خديجة ومفتاح العودة
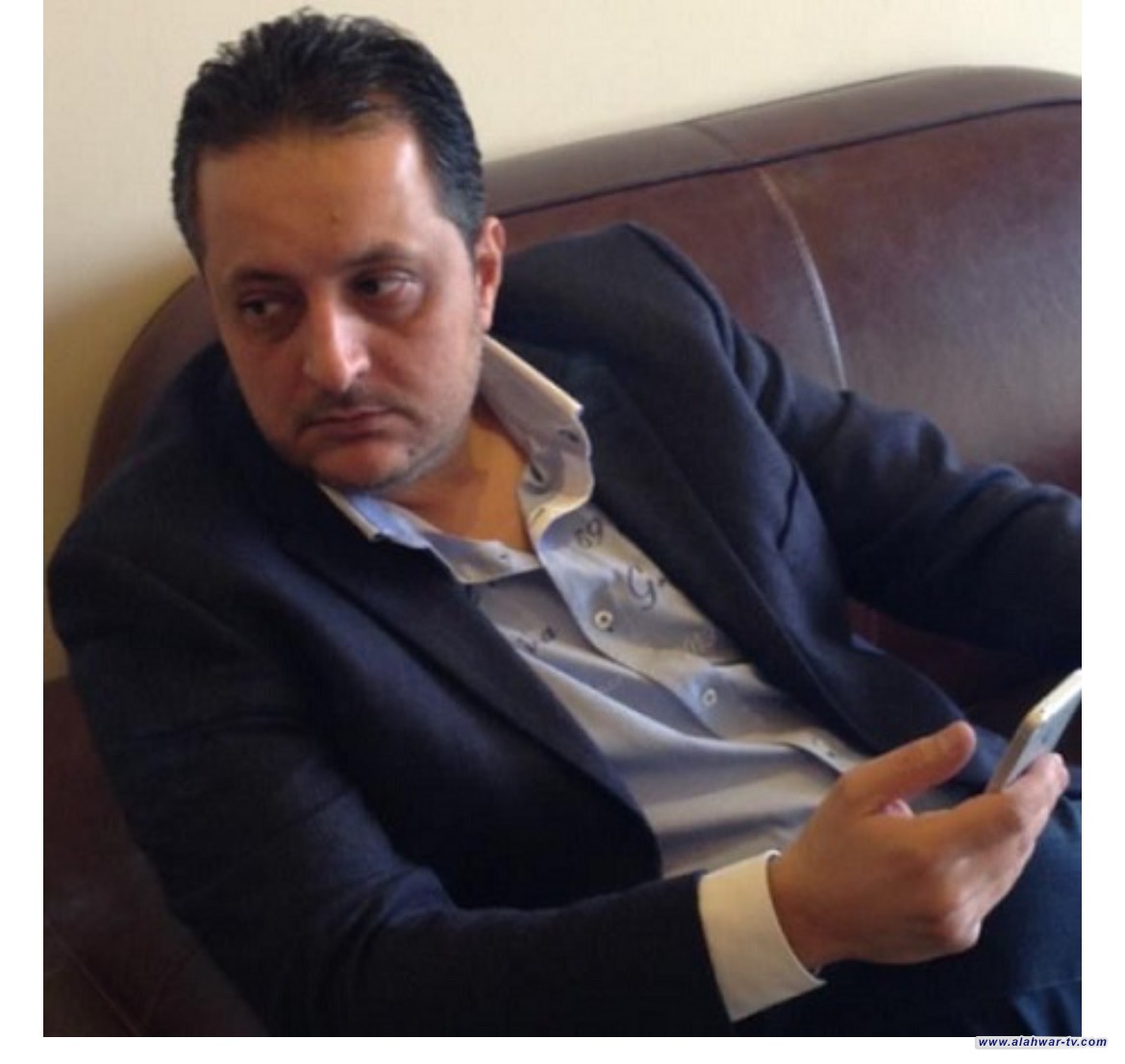
كانت تبلغ من العمر بضعة سنوات عندما هاجمت عصابات الصهاينة قريتها، مما أضطر أهلها للخروج هربا بإتجاه لبنان فبلدتهم من البلدات القريبة للحدود اللبنانية الفلسطينية،
خرجوا ليلا يقطعون المسافة متعجلين قدر ما يستطيعون، خوفا من أن يلحق بهم الصهاينة فقد سمعوا الكثير عن المجازر التي أرتكبتها عصابات الشتيرن والهاغانه والأرغون ،المسلحة جيدا من مخزون الجيش البريطاني التي تركها لهم قبل أن يغادر الأراضي الفلسطينية،
كانت خديجة لا تعي ما يحصل حولها فقد كانت في السادسة من العمر تمسك بيد جدتها ،وجدها يضع أخاها الأصغر على منكبيه أما والدتها فقد كانت حاملا في شهرها الخامس، وكانت تعاني صعوبة في المشي وأما والدها فكان يعين أمها تارة وتارة ينحني بما يحمل من أغراض المنزل الذي إستطاع حمله ،
ولم تفهم لما أوقفتهم جدتهم بعد مسير ربع ساعة لتصر على العودة كي تقفل الأبواب والنوافذ وتغلق الباب ، وتقفله بالمفتاح وتضعه أي المفتاح في صدرها ناحية القلب وكل ظنها أنها ستعتازه قريبا .
وصلوا إلى الحدود اللبنانية عند شروق الشمس بعد مسير أستمر من بعد صلاة العشاء، وهناك هالهم ما رؤا الآلآف بل عشرات الآلاف من الهاربين تاركي أرضهم ورزقهم وهم يتجمعون على معبر الناقورة ، بإنتظار السماح لهم بالدخول كان الجو السائد يوحي وكأنه يوم القيامة بكاء نساء وأطفال يملأ المكان، ورجال قد أذلهم خروجهم من أرزاقهم وبيوتهم ودكاكينهم ولا يدرون ما المجهول الذي ينتظرهم،
ويحاولون أن يؤمنوا بعضا من طعام أو ماء جاد به سكان القرى اللبنانية على الحدود، كانت خديجة ولأول مرة تشاهد هذه النظرات في عيون (سيدها) جدها ووالدها، ولم تستطع أن تفهم هذه النظرات التي تراها لأول مرة وفهمتها عندما كانت تتذكر تلك الليلة ،بعد أن كبرت وعرفت معنى الأسى والذل والإحباط في عيون من تحب .
دخلوا الأراضي اللبنانية قرابة العاشرة ليلا وهم لا يعرفون أين يذهبون وماذا يفعلون كيف يجب أن يتصرفوا، والنقود التي معهم هل لا زال لها قيمة بعدما إختفى الوطن الذي أصدرها، أكملوا طريقهم مشيا لساعات أخرى حتى وصلوا إلى مكان سبقتهم إليه جماعات من اللاجئين،
وبدؤا بالإستقرار المؤقت فيه وهو ما سيدعى لاحقا بمخيم الرشيدية جنوبي صور ،إفترشوا الأرض وألتحفوا السماء وناموا بعد يومين من المشي والتعب والقهر ، إستيقظوا مع شروق الشمس وقد كانت الحركة قد بدأت حولهم، هذا يبحث عن ماء وهذا يبحث عن طريقة لإشعال النار وهؤلاء يحاولون تأمين بعض الطعام،
الحق أقول بأن أهل القرى الجنوبية تقاسموا حرفيا ما لديهم مع أخوتهم اللاجئين، بدأ وصول مؤسسات الدولة لتحصي ولترى ماالذي تستطيع تقديمه وكذلك جمعيات متنوعة،
ولكن المؤسسة التي كانت وكأنها تتوقع ما سيحصل وجهزت أمورها على هذا الأساس ،فكانت (الأونروا) أي وكالة غوث اللاجئين الفلسطينين فبدأت بالخيم للفرش للأغطية لإستلام التجمع وتحويله إلى مخيم ،مع إقامة دورات مياه بمعنى آخر كانت مهيأة لتساعد الفلسطينيين على الإستقرار ضمن تجمعات وأن ينسوا أي تفكير بالعودة .
بدأت حياة العائلة بالإستقرار وسط الكم الهائل من الخيم والتوزيع اليومي للطعام والشراب، أما بالنسبة لخديجة فهي لا تفقه شيئا مما يجري حولها سوى أن جدتها ووالدتها يبكيان طوال الوقت، وأنها تعرفت على طفلين من سنها أحدهم بنت والآخر صبي وهم لعائلة لاجئة أيضا ،
فكانت تقضي أغلب أوقاتها معهم في اللهو واللعب ومن ناحية المحيط لم يتغير عليها الكثير ،فمنطقة الرشيدية تحيط بها البساتين وكذلك بيتهم والبساتين التي يمتلكها جدها بجوار المنزل ،
ولكن الفرق أنها هناك كانت ملكا لعائلتها أما هنا فأصبحوا بعد فترة عمال مياومين (شغيلة فاعل)بهذه البساتين، يخرجون صباحا ليعودوا وقد أنهكتهم المذلة والتعب والكرامة التي ضاعت مع الوطن . بدأت الأمور تنتظم في المخيم من مأكل للمياه للتعود على هذا النمط الجديد، من المهانة ودفن الكبرياء الذي لا يسمن ولا يغني من جوع وبدأت الأونروا بإعداد مدارس في بعض الخيم للأطفال ،
وكانت خديجة من بينهم كانوا يكلمونهم في المدرسة عن كل شيء من الرياضيات إلى اللغة العربية إلى إحدى اللغات الأجنبية ،إلى التاريخ والجغرافيا ولكنهم لم يأتوا على ذكر فلسطين ولا مرة وكأنها غبار تزروها الرياح ،ولكن الجميع في البيت (الخيمة) لم يقصروا في الحديث عن فلسطين حتى من كان حديثه قليل نسبيا كان يتكلم عندما تذكر فلسطين ،
كبرت خديجة وأصبحت في سن المراهقة وتسجلت في أحد مدارس صور وكان مشوارا متعبا كل يوم صبحا ومساء في الذهاب والعودة إلى المدرسة.
إستيقظت خديجة في إحدى الليالي على صوت تمتمة آتي من الغرفة المجاورة وقد كانوا بدؤا يستبدلون الخيم بالغرف التي بنيت بطريقة عشوائية، إقتربت ووجدت أمها تجلس قرب فراش جدتها المريضة منذ فترة وجدتها تمسك بيدها شيء ما وتعطيه لأمها، وتوصيها ببضعة كلمات لم تفهم الكثير منها
ولكن بعد بضعة أيام من وفاة جدتها سألت أمها عن تلك المحادثة، فأخبرتها والدتها أن جدتها أعطتها مفتاح منزلهم في فلسطين المحتلة وأوصتها أن تحتفظ به ،فإما يقدر لها إستعماله أو تتركه كتركة لأحد أبنائها المهم أن تحفظه وتحافظ عليه ،أصبحت خديجة شابة مكتملة النضج وهي وإن توقفت عن الدراسة بعد نيلها شهادة الثانوي ،إلا أنها كانت مغرمة بالقراءة كانت تقرأ في كل شيء وأي شيء وبعد فترة تقدم لخطبتها شاب لبناني كان قد رآها في مشاويرها للمدرسة ،
وافقت خديجة ووافق الأهل على الشاب وهو متعلم ويعمل في مجال الصحافة مهذب ودمث الخلق أحبته خديجة وأحبها، وبعد فترة من الزمن كان لديهم ولدين بنت وصبي كلف محمود وهذا أسم زوجها بالسفر إلى أميركا ليؤسس مكتبا للصحيفة، التي يعمل بها وهذا ما كان سافر أولا وبعدها أرسل يطلب زوجته وولديه . إستقرت العائلة في إحدى المدن الأميركية وكانت حياة جديدة ومختلفة عما عهدوه سابقا، ولكن شيئا فشيئا بدأت العائلة تتعود على هذا النمط الجديد من الحياة وكانوا دائما ما يعودون للبنان لزيارة العائلة،
تقريبا كل سنتين يأتون بإجازة توفي جدها ومرت الأيام وفي إحدى زياراتها الأخيره كانت والدتها على فراش المرض ،فطلبت أن تختلي بها لتعطيها الأمانة التي كانت موكلة بهاوهو مفتاح العودة وأعادت على مسامعها ما سمعته من جدتها ، وطلبت منها عهدا ووعدا أن تحافظ عليه وتحفظه دمعت عيناها وهي تأخذ من أمها المفتاح وبقيت تفكر بما تحمل طوال طريق السفر إلى أميركا،
وكانت بين فترة وفترة تطال المفتاح وتنظر إليه وتتفقده بعد أن وصلوا إلى بيتهم في أميركا ،وضعت المفتاح في مكان آمن وبقي معها لحين بلغها بعد فترة وفاة والدتها ، حزنت خديجة على والدتها وتذكرت المفتاح وأخذت تراجع في ذاكرتها ذكرياتها ، من خروجهم القسري من فلسطين ووصولهم إلى جنوب لبنان وكيف بدؤا حياة جديدة وكل التفاصيل التي عاشوها في لجوئهم،
إلى اللحظة التي غادرت فيها لبنان إلى أميركا لعدة سنوات خلت حتى غدت بأجزاء كثيرة من مظهرها أو داخلها أميركية ،بلغت خديجة الواحدة والثمانين وكبر أولادها وتزوجوا وأنجبوا لها أحفاد ،ولكن عينها كانت دائما على التلفاز تتابع أخبار فلسطين ولبنان حتى جاء السادس من أكتوبر،
إختلطت عليها المشاعر الفرح السعادة القلق إستعادة الكرامة والخوف من القادم تذكرت المفتاح وهي لم تنسه أبدا ،ذهبت إلى حيث وضعته في خزنة المنزل أخذته وضعت له طوقا ولبسته كقلادة إلى جانب قلبها ،وبدأت تعي ما الذي تعنيه هذه القطعة من المعدن التي بلغت من العمر المائة وبما تختزنه من معاني وذكريات،
لم تستطع أميركيتها أن تنسيها فلسطينيتها وأخذت تفكر متى سيأتي اليوم الذي سيستعمل فيه هذا المفتاح ،ومن الذي قدر له أن يستعمله وأن يفتح به باب المنزل وهل ستكون وقتها من الأحياء لترى وتفرح، بالعودة أم ستشاهد روحها التي ترفرف فوق بيتهم في فلسطين ذلك .
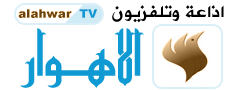









ارسال التعليق